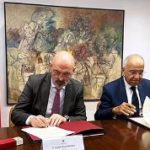بقلم : الخضير قدوري
العنف ضد المرأة ولبيت الزوجية وضد الطفل والحياة الأسرية وضد الآباء والأصول العائلية واليوم العنف ضد المعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية وضد المارة في الشوارع والأسواق العمومية وغدا العنف ضد المصلين في المساجد والموظفين في الإدارات وبالتالي العنف ضد المجتمع والدولة ككل ثم ماذا بعد غد وما الداعي يا ترى للعنف والى التعايش المفروض مع العنف باسم الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان في ظل التسيب المتفشي بشكل ذريع على حساب المعنفين في غياب القوانين الرادعة واليوم قبل الغد أصبح يفرض حصر المسؤلية في جانب احد الأطراف الثلاثة الأسرة والمدرسة ثم الدولة كما سيصبح الغد بعد اليوم يلح على ضرورة وضع حد لهده الظاهرة المخزية والعمل على معالجتها قبل استفحالها فيصبح هذا المجتمع عرضة لأمراض قد يستعصي اشفاؤها وتجعل الدولة قاب قوسين أو أدنى من السقوط والانهيار ومن سيقلل من أهمية الظاهرة في ظل التحولات السريعة والتقلبات المفاجئة التي يشهدها العالم قد يكون كائنا خارج التغطية السياسية والثقافية والفكرية وبالأحرى ابعد ما يكون من الحياة على الكرة الأرضية فإذا كانت أصابع الاتهام تتوجه إلى الأطراف الثلاثة المذكورة فان اثنين من ثلاثة تجدان لهما مبررات تجعلهما تلقيان باللائمة على الدولة و بالمسؤلية في ملعبها حيث أصبح الوضع يستدعي المجتمع بكل فئاته باعتباره الحاكم الذي يمكنه أن يحدد المسؤلية في جانب احد الأطراف المتهمة فإذا كنا جزءا من فئات هذا المجتمع التي تحرص على حماية الحق العام فان دفع الأسرة يحدد مسؤليتها على النشئ رضيعا وصبيا فطفلا قد تتحلل من هذه المسؤلية عندما تضع زمام أمرها بيد المدرسة ويبلغ النشئ سنا تجعله يتجاوز المراحل الأولية من حياته حيث تبدأ مسؤلية المدرسة والجامعة فالدولة التي يجب أن يبقى دورها مواكبا لكل مراحل النشئ من مهده إلى لحده فإذا كانت الأسرة والمدرسة تملكان وسائل التوجيه والتلقين والإيضاح فان الدولة لم تكن تمكنهما من أدوات العمل أو تدعمهما باليات التفعيل المتمثلة في منظومة تربوية تتوفر على برامج هادفة تتماشى مع الطبيعة العقلية وتتلاءم مع التقاليد الاجتماعية وتتناسب مع الشرائع الدينية قد نكون كمجتمع وكمدرسة ودولة فرطنا متعمدين أو متهاونين في هذه المبادئ السامية التي كان من نتائج هذا التفريط ما نراه ونجده ينعكس سلبا على المدرسة والأسرة والمجتمع ككل ويولد العنف والانحراف قبل أن يصبح الفكر الاستعماري مفعلا على ارض واقعنا كان هذا الفكر يستند إلى حكمة نابليون القائلة فيمن يعلم حرفا من لغة المستعمر أفضل بكثير ممن يحمل البندقية بذلك يكون قد أدى لوطنه خدمة لن تتقادم بتقادم الزمان أو تنتهي بانتهاء فترة الاستعمار . فان كان هذا الأخير قد غادر أرضنا ورحل عنا بأدواته ومعداته والياته مند أكثر من نصف قرن مع ذلك تبقى أفكاره وثقافته ورواسبه ضاربة في أعماق الأجيال لعشرات السنين باعتبارها أفكارا مثالية وثقافية و حضارية ولغة معاصرة بها يتم التعامل والتكامل والتواصل قد تكون مقولة نابليون حكمة بليغة لحدود كتابة هذه السطور لم يتخلص المجتمع المغربي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة من هذه الظاهرة من يوم تخلى فيه عن حماية عاداته وتقاليده وثقافته وأقدمت منظومته التربوية على إلغاء مواد التربية الوطنية والإسلامية والأخلاق من برامجها التعليمية باعتبارها مواد أساسية ومن أهم مكونات الإنسان المغربي و العربي ومن القواعد الضرورية التي يتطلبها بناء صرح الأوطان . فإذا كان مجتمعنا يخلو سلوكه من أخلاق طيبة وتربية حسنة وروح وطنية ومن الإيمان بالعقيدة الدينية فقد يصنف ضمن صنوف المجتمعات المريضة التي يؤدي مرضها إلى فساد الأمة فإذا فسدت الأمة فقد يؤدي فسادها إلى سقوط الدولة ومن اشراط سقوطها عجزها عن إصلاح مفاسدها ومحاربتها للفساد فيها وعجزها عن حماية مؤسساتها وتمنيع مجتمعاتها بفعالياتها الثقافية والفكرية والإبداعية فلا حياة لدولة تعطل ملكة الإبداع في نفوس مبدعيها وتقتل الروح الفاعلة لديها تلك مصيبتنا في دولتنا فلا خير في مجتمع يعتمد في حياته على فضلات غيره ولا حياة لدولة تجعل أرضها مطرحا لنفايات أمثالها .
 إعلان هام .. افتتاح عيادة للطب العام بتاوريرت
إعلان هام .. افتتاح عيادة للطب العام بتاوريرت بلاغ امني : مستجدات في قضية الشابة ضحية الإجهاض .
بلاغ امني : مستجدات في قضية الشابة ضحية الإجهاض .


 هذه هي حقيقة مدينة تاوريرت .. بــدون روتــوش
هذه هي حقيقة مدينة تاوريرت .. بــدون روتــوش









 من كان يعبد هبلا فان هبل قد رحل .....
من كان يعبد هبلا فان هبل قد رحل .....